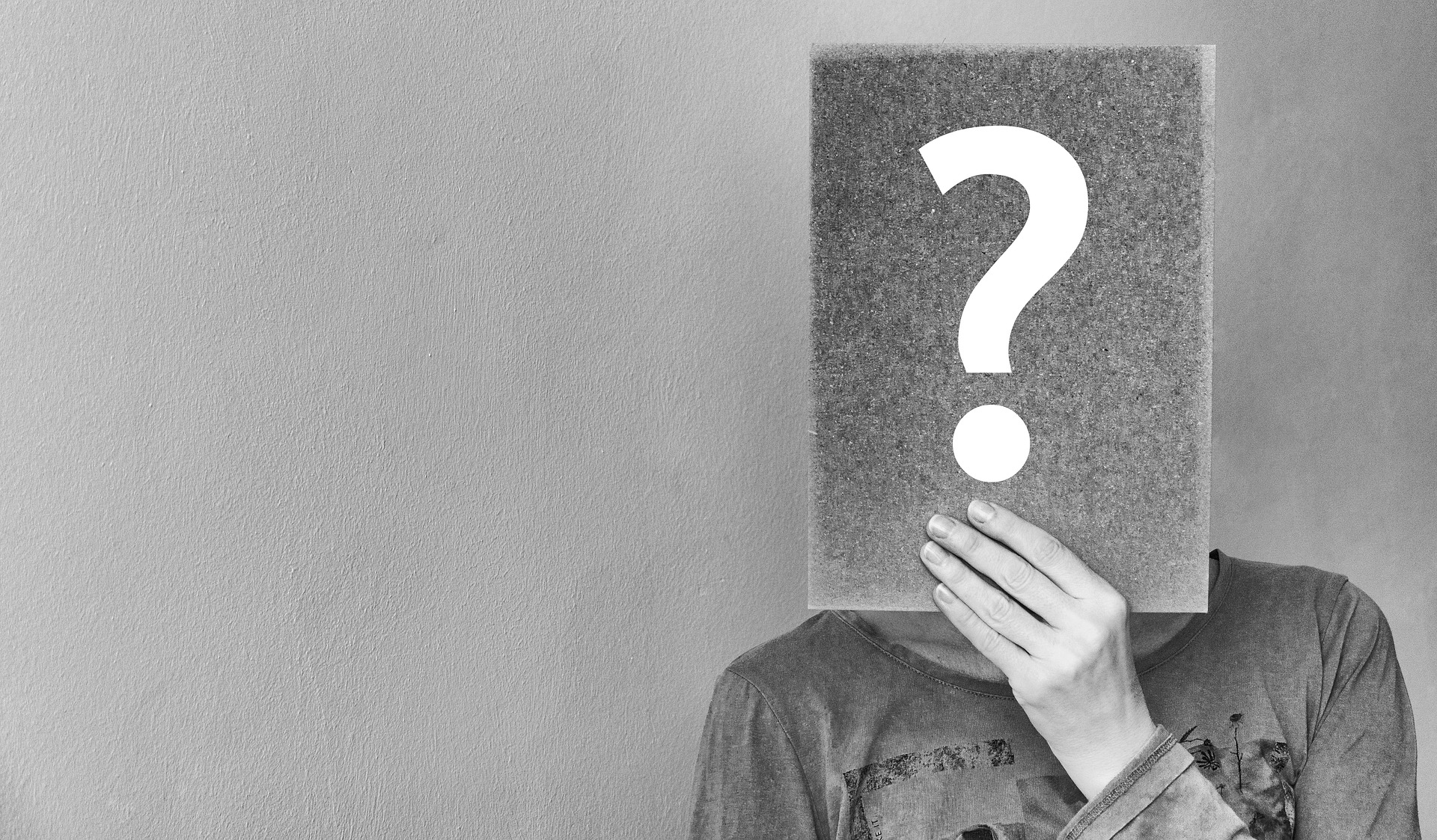الإقتصاد التشاركي
2022/05/12
نموذج عمل أو استراتيجية توسع؟
مقال نشرته في تاريخ 20-4-2017
بعد دراستي لعدد من الشركات التي تعتمد عليه، كنت مؤمن بأن تحقق الجدوى المالية من الإقتصاد التشاركي يلزمها بناء نموذج مستدام، بمعنى أن الإقتصاد التشاركي بحد ذاته ليس نموذج مستدام، ولكنه استراتيجية توسع سريع، يلزم صاحب المشروع تغييرها وقت وصوله للحجم المطلوب. من خلال النقاش اتضح لي أني هناك جانب كبير لا يزال مجهولاً لدي، فبدأت البحث حول الموضوع وفي هذا السلسلة من المقالات سألخص أهم ما وجدته من معلومات. يتوجب التنوية أن الإقتصاد التشاركي هو علم جديد لا يزال تحت التشكيل والتغيير، والأبحاث حوله لا تزال محدودة.
ما هو الإقتصاد التشاركي وكيف بدأ؟
كانت عملية المشاركة ولا زالت بديلة لعملية البيع، منذ طفولتنا وقبل أن نعرف الإنترنت تعودنا على استعارة الكتب، والأفلام، وألعاب الفيديو. وكذلك فعل آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا قبلهم، استعاروا قدور الطبخ، أدوات الحراثة والصيد وغيرها. الهدف من عملية المشاركة تلك كانت زيادة الفعالية، جارك لديه آلة أو شيء غير مستخدم بفعالية، وأنت لديك احتياج لإستخدام ذلك الشيء، بدل شراءه ويصبح في حيكم آلتين لا تستخدم بفعالية، يصبح لديكم آلة تستخدم بفعالية أكبر. وبالتالي قد يصبح لديك وفر مالي من العملية، تستخدمه لشراء آلة اخرى يحتاجها جارك، وهكذا. يمكن تلخيص الأسباب التي يتشارك الناس من أجلها بأربعة أسباب: إجتماعية (تكوين علاقات جديدة أو المحافظة على حالية)، إقتصادية (توفير المال)، عملية (تقليص الوقت، تحسين النتائج)، وأخيراً الإستدامه (المحافظة على البيئة). وهذه الأسباب مهم تذكرها عند التفكير في نموذج العمل الخاص بمشروع قائم على الإقتصاد التشاركي. مصطلح الإقتصاد التشاركي (Sharing Economy) بدأ بالظهور في بداية الإلفية، متأثراً بالركود الإقتصادي في سنة 2008م، والحاجة لتلبية تنامي الطلب وانخفاض الموارد. ومنها أشتق مفهوم الإستهلاك التعاوني (Collaborative Consumption) والذي صنفته مجلة تايم كأحد عشرة أفكار ستغير العالم.
إقتصاد تشاركي أم إقتصاد دلالة؟
لاحظنا أن عملية التشارك تقوم على طرفين شخص يملك غرض، وآخر يرغب في استخدامه. الرابط الذي يجمع الطرفين في الأساس هو المعرفة الشخصية، ولكن في حالات وللوصول إلى شريحة أكبر وأوسع يحتاج الطرفين إلى طرف ثالث وهو الدلال أو المسوق. الهارفرد بزنس ريفيو بنسختها الإنجليزية نشرت مقالاً عنوانه "الإقتصاد التشاركي لا يدور حول المشاركة على الإطلاق" (The Sharing Economy isn't about Sharing at all). كاتب المقال يدعي بأن الشركات القائمة على الإقتصاد الحالي هي في الواقع تقوم بإقتصاد الدلالة أو الوصول (Access Economy)، كون العملية في الواقع ليست مشاركة بين أطراف بينهم سابق معرفة، ولكنها تربط بين مقدم خدمة ومستخدم لها، والشركة الرابطة في الواقع تأخذ بدل (عمولة) على عملية الربط تلك. بالتالي ولو رجعنا للأسباب الأربعة للمشاركة، يمكن القول بأنه وفي إقتصاد الدلالة، يبرز عنصرين أساسين، وهما: الإقتصادية والعملية. فالعميل حين يدفع مبلغاً مالياً للوسيط، هو يبحث عن خدمة إقتصادية وعملية في الوقت ذاته. في أوبر مثلاً، معظم العملاء لا يطلبون السائق للتعرف عليه مثلاً، بل مستخدم الخدمة فلا يستطيع إعادة طلب مقدم خدمة جيد في المستقبل. مقال الهارفرد بزنس ريفيو يضيف أن استيعاب هذه النقطة هو أحد أسباب تفوق أوبر على لفت في الولايات المتحدة. اوبر تستخدم مصطلح (أفضل، أسرع، وأرخص من التاكسي)، بينما لفت تستخدم (نحن أصدقائك ومعنا سيارة).
الربحية في إقتصاد الدلالة
شركات الربط تتنافس فيما بينها على صعيد، وعلى الصعيد الآخر تتنافس مع الشركات التقليدية الموجودة على أرض الواقع. نطاق التنافس فيما بينها يكون في ضبط العرض والطلب بجلب أكبر عدد من المستخدمين ومقدمي الخدمات. ومع الشركات التقليدية بضبط التكاليف وتوفير وصول وأسعار أفضل. كما لاحظنا أن عملية التبادل التي تحصل في إقتصاد الدلالة مكونة من ثلاثة أطراف، مقدم الخدمة، المستخدم، والجهة الرابطة. لتنجح الجهة الرابطة في مهمة الربط، يتوجب عليها ضمان معايير الجودة، وتقديمها بسعر منافس للمستخدم مع الحصول على نسبة جيدة كعمولة. معظم تكلفة الإلتزام بمعايير جودة الخدمة تقع على مقدم الخدمة. مثلاً نظافة السيارة وصيانة المنزل، شحن البضاعة، أو التأمين. والذي ونظراً لأنه لا يملك قوة في المفاوضة كما هو الحال لدى الشركات الكبيرة، سيضطر للقيام بها حسب تكلفة السوق للمستهلك النهائي، وهي أعلى. بعض المشاريع التشاركية تظهر وكأنها تعمل بفعالية ليس لأنها كذلك، ولكن لأن التكاليف الفعلية لا تسجل (فوربس). وحسب ماتذكره الإندبندت أن جزء من هذا التكاليف هو في الواقع ناتج عن عدم وقوع الخدمات المقدمة ضمن نطاق الرسوم والضرائب والتنظيمات التجارية، والتي لا بد وأن يلحقها التنظيم في المستقبل. نقطة القوة التي تمتلكها شركات الربط مقابل الشركات التقليدية هو الوصول. شركات الربط تستخدم التقنية لربط مستخدم الخدمة بكفاءة وفعالية عالية. كما وأن تواجدها على نطاق جغرافي كبير، يعطي علامتها التجارية قوة تفوق الشركات التقليدية التي قد لا تعرف إلا على نطاق جغرافي محدود. ولكن عند النظر إلى تكلفة العمليات فإن هدف الشركات الكبيرة هو المحافظة على نسب إشغال عالية، متوافقة مع خطط الإستثمار. أي أنه وبمجرد الوصول إلى نقطة التعادل (Break-even point) فإن الشركة الكبيرة تستطيع خفض الأسعار لمستويات متدنية جداً، قد لا تستطيع شركات الربط الوصول إليها. خصوصاً وأنه وكما ذكر مسبقاً، شركات الربط التي توظف الإقتصاد التشاركي لا تعمل بكفاءة عالية، وأنها في الوقت ذاته عبارة عن شريحة تكلفة إضافية في السوق. بالتالي يمكن القول بأن أحد الإستراتيجيات التنافسية الأساسية لشركات الربط، توظيف نموذجي تكلفة للقدرة على التنافس. في الأسواق ذات الطلب العالي والتي بطبيعة الحال يتواجد فيها عدد كبير من الشركات الكبيرة، يتم تبني بناء شراكات مع الشركات الكبيرة، بحيث تكون شركة الربط وسيط لتلك الشركات التي تعمل بكفاءة. أما في المناطق التي لا يتواجد فيها طلب عالى، فيتم استخدام نموذج توظيف الأفراد قليلي الكفاءة. بطبيعة الحال ونظراً لإنخفاض التكلفة التشغيلية فإن الشركات الكبيرة يمكنها النزول بالأسعار المعروضة لمستويات يستحيل معها للأفراد المنافسة.
الإقتصاد التشاركي نموذج عمل أم استراتيجية توسع؟
الناس تتشارك لأربعة أسباب رئيسية: اجتماعية، اقتصادية، عملية، وللاستدامة. في إقتصاد الدلالة يتم التركيز على عنصرين هما: الإقتصادية والعملية.بالتالي يمكن القول بأن ما يطلق عليه الإقتصاد التشاركي في الغالب هو إقتصاد دلالة، يقوم على الربط بين مقدم خدمة ومستخدم لها مقابل عمولة. ولكون المشاركة قرين لقلة الكفاءة، فإن الأفراد يميلون للبدء في دخول كمقدمي خدمات في منصات الإقتصاد التشاركي، رغبة منهم في رفع كفاءة أوقاتهم أو خدماتهم. نسبة من تكاليف العمليات لا تسجل، وبالتالي لا يمكن قياسها. أو لم تفرضها الحكومات على شركات الإقتصاد التشاركي. نقطة القوة الرئيسية لشركات الربط هو الوصول وقدرتها على تشكيل سوق فيه عرض وطلب بشكل صحي. مع نمو شركات الإقتصاد التشاركي، سيكون عليها تحسين هيكلة التكاليف المتعلقة بالخدمات المقدمة لرفع مستوى الربحية والقدرة على المنافسة، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيدفع بالجهات ذات معدلات الكفاءة المنخفضة للخروج (الأفراد)، وبقاء الجهات ذات الكفاءة العالية (الشركات).